لماذا لا يدفع الله الأمراض والبلايا والظلم؟
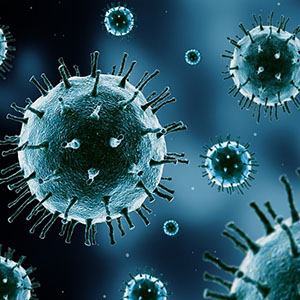
المصدر:
كتاب جدلية الإلحاد والدين
صفحة: 167
السؤال (27): الأمراض والبلايا والظلم في كلّ مكان، فأين هو الله من كلّ ذلك؟
والجواب:
1- كفاية قدرة الإنسان على دفع الأمراض والظلم: فإنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وأعطاه العقل والتدبير والعلم كما قال سبحانه: (عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق: ٥]، وبيّن له أنّ كلّ ما حصل عليه من العلوم قليل، فقال: (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) [الإسراء: ٨٥]، وحثَّه على طلب المزيد من العلم، فقال سبحانه: (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا) [طه: ١١٤]، ووعد الإنسان بكشف آفاق العلم إليه، فقال: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) [فصلت: ٥٣ ]، مع ما وهبه من القدرة على الاكتشاف والابتكار والاستنتاج والاختراع وغير ذلك.
مضافاً إلى كلّ هذا فإنّه سبحانه سخَّر للإنسان كلّ إمكانات الحياة الهائلة جدًّا، فقال سبحانه: (اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الجاثية: ١٢ - ١٣].
إذا عُلم ذلك نقول: إنّ الله لما أعطى الإنسان كلّ هذه الإمكانيات صار قادراً على اكتشاف الأدوية والعلاجات لجميع الأمراض وعلى مكافحة الأوبئة، ونحن نعتقد أنّه ما من داء في الأرض إلا وقد خلق الله له دواء.
فقد روى ابنا بسطام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال: أنزل الله الداء، وأنزل الشفاء، وما خلق الله داءً إلا جعل له دواء. (طب الأئمة: 63).
ولهذا نجح الإنسان في معالجة كثير من الأمراض، وبقي عليه أن يبذل جهده في محاربة باقي الأمراض الأخرى، وقد استطاع الإنسان أخيراً أن يقضي على بعض الأمراض التي كان علاجها يُعَدُّ مستعصياً عليه، كمرض الجدري مثلاً الذي أعلنت منظمة الصحّة العالمية في عام 1980م عن استئصاله من العالم بالكامل. (http://www.who.int/topics/smallpox/ar).
وأمّا الظلم فإنّه بفعل الإنسان، والمظلومون قادرون على رفع الظلم عن أنفسهم إذا تضافرت جهودهم، ووحَّدوا صفوفهم، واتّحدوا ضدّ الظالم، فإنّ ذلك ربّما يكون من أسباب ارتفاع الظلم.
وبتعبير آخر: إنّ الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على رفع الظلم عن نفسه، والله سبحانه لم يخلق ظالماً لا يُقهر، وحوادث التاريخ أدلّ دليل على صحّة ما قلناه، فكم من حاكم جائر اندحر وهلك لما ثار عليه المظلومون، وثأروا لأنفسهم.
2- جناية الإنسان على نفسه: فإنّ كثيراً من الأمراض ربّما يصاب بها الإنسان بسبب إهماله وتقصيره في العناية بنظافة جسمه وطعامه، مثل الطاعون وغيره من الأمراض المعدية.
كما أنّ عدم تنظيم الإنسان لطعامه كمًّا وكيفاً، بتناول الأطعمة غير الصحّية بكميات كبيرة، ربّما يصيبه بكثير من الأمراض الخطيرة التي لا يتمكّن الأطباء بعد ذلك من معالجتها، وربّما تودي بحياته في نهاية المطاف، مثل ضغط الدم، ومرض السكّري، والسرطان وغير ذلك.
مضافاً إلى أنّ سوء تصرّف الإنسان الذي لا يراعي القانون الإلهي قد يصيبه بكثير من الأمراض الفتّاكة، كالأيدز، والزُّهري، وغيرهما من الأمراض الجنسية التي تحدث عادة بسبب العلاقات غير المشروعة.
وبقول مختصر: إنّ إصابة الإنسان بالأمراض ناشئة في أكثر الأحيان من تقصيره وإهماله وعدم محافظته على صحّته.
فهل يحقّ للإنسان بعد ذلك أن يلقي باللوم على الله تعالى؛ لأنّه لم يعالجه من مرضه الذي تسبَّب هو فيه؟ مع أنّ الله تعالى بيَّن له بالتفصيل - قبل إصابته بالمرض - ما ينفعه وما يضرّه من المأكولات والمشروبات والأفعال القبيحة التي قد تودي بحياته، ثمّ حذّره من تناول تلك المأكولات والمشروبات وارتكاب تلك الأفعال الضارّة التي حرّمها عليه، حيث أباح للإنسان أكل الطيِّبات، ونهاه عن أكل الخبائث كما قال سبحانه: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ) [الأعراف: ١٥٧]، ومع ذلك فإنّه سبحانه خلق له المواد التي يمكن أن يصنع منها الدواء لكلّ داء، وأمره بالاستفادة منها.
وكذلك الحال في الظلم الذي يقع على الناس، فإنّه في أكثر الأحيان بسببهم هم؛ لأنّ الناس عندما يبتعدون عن تعاليم الله تعالى التي تكفل لهم الحياة السعيدة، فيرتكبون المعاصي، ويعملون الفواحش والموبقات، ويظلم بعضهم بعضاً، ولا ينكرون على الظالم ظلمه، بل يجاملونه، ويصحّحون أعماله القبيحة، ويشجّعونه عليها، أو يكونون من أعوانه الذين يعينونه في ظلمه، فإنّ الظالم سيتمادى في ظلمه، والله تعالى حينئذ لا يرفع عنهم هذا الظلم الذي وقع عليهم؛ لأنّه أصابهم بجنايتهم على أنفسهم؛ ولأنّهم لا يستحقّون أن يغضب الله لهم بسبب كثرة معاصيهم.
قال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) [الشورى: ٣٠].
3- ابتلاء الله تعالى لخلقه: فإنّ الله تعالى لم يجعل الدنيا دار قرار ونعيم، وإنّما جعلها دار بلاء وامتحان؛ ليثيب المحسن على إحسانه في جنّته، ويعاقب المسيء على إساءته في نار جهنّم، فشرع للنّاس الشرائع السماوية، وأرسل لهم الأنبياء والرسل، وأنزل لهم الكتب، وبيَّن لهم ما ينفعهم وما يضرّهم، ليحيا من حيَّ على بيِّنة، ويموت من مات على بيِّنة.
والله تعالى نهى عباده عن ظلم بعضهم بعضاً، وتوعّدهم، وحذَّرهم من عواقب الظلم في الدنيا والآخرة، وآلى على نفسه ألّا يفوته ظلم ظالم، وأن ينتصف لكلّ مظلوم من ظالمه.
ولكنّ الله تعالى ابتلى بعض الخلق ببعض، فابتلى المظلوم بالظالم؛ ليرى هل يصبر أم يكفر، وابتلى الظالم بالمظلوم، فسلّطه عليه؛ ليرى هل يظلمه أم ينصفه.
والله تعالى وإن أمهل الظالم في الدنيا، فلم يعاجله بالعقوبة لحكمة سيأتي بيانها، إلا أنّه سبحانه سيعاقبه ولو بعد حين؛ لأنّه لا يفوته ظلم ظالم.
وأمّا الأمراض فمع أن المتسبِّب فيها كلّها هم الناس أنفسهم كما بيَّنا فيما تقدّم، إلا أنّها تدخل أيضاً فيما يبتلي الله تعالى به العباد، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين.
4- معاجلة الظالمين بالهلاك: فإنّ الله تعالى عاقب كثيراً من الظالمين في الأرض، فعجَّل بإهلاكهم، ولم يُطِل أعمارهم كما كانوا يحبّون، وقضى مُدَدهم بأسرع ممّا كانوا يظنّون، وربّما أمرضهم بالأمراض الشديدة المؤلمة قبل أن يهلكهم كما حصل ذلك لكثير من العتاة والطواغيت:
منهم: يزيد بن معاوية (25 أو 26، أو 27-64هـ)، مات وعمره 39 سنة أو 38، أو 37. (البداية والنهاية 8/239).
ومنهم: الحجّاج بن يوسف الثقفي (40-95هـ)، الذي هلك وله من العمر 55 سنة لم يتجاوزها. (نفس المصدر 9/145).
ومنهم: أكثر الخلفاء الأمويين والعباسيين، فإنّهم كانوا ظالمين طواغيت، قد قصم الله أعمار أكثرهم بسبب ظلمهم وجورهم، كالوليد بن عبد الملك بن مروان (50-96هـ)، الذي مات وعمره 46 سنة، وقيل: 49، وقيل: 44. (نفس المصدر 9/168).
وسليمان بن عبد الملك بن مروان (54-99هـ)، مات وعمره خمس وأربعون سنة، وقيل: 43، وقيل: 39. (نفس المصدر 9/184).
ويزيد بن عبد الملك بن مروان (72-105هـ)، مات وعمره 33 سنة، وقيل: 35، وقيل: 38، وقيل: 39، وقيل: 40 سنة. (نفس المصدر 9/242).
وهشام بن عبد الملك بن مروان (72-125هـ)، مات وعمره 53 سنة.
والوليد بن يزيد بن عبد الملك (90-126هـ)، قُتل بسبب فسقه واستهتاره وتجاهره بالمنكرات، وكان عمره حينئذ 36 سنة.
ويزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (90-126هـ)، ولي الخلافة ستّة أشهر، ومات بالطاعون، وعمره 36 سنة.
قال ابن كثير: وأكثر ما قيل في عمره: ستّ وأربعون سنة، وقيل: ثلاثون سنة، وقيل غير ذلك، فالله أعلم. (نفس المصدر 10/18).
وأمّا خلفاء بني العباس فأوّلهم: أبو العباس عبد الله السفاح الذي مات في سنة 136هـ.
قال ابن كثير:
توفّي بالجدري بالأنبار يوم الأحد الحادي عشر، وقيل: الثالث عشر من ذي الحجّة سنة ستّ وثلاثين ومائة، وكان عمره ثلاثاً، وقيل: اثنتين، وقيل: إحدى وثلاثين سنة، وقيل: ثمان وعشرين سنة، قاله غير واحد. (نفس المصدر 10/60).
ومنهم: المهدي ابن المنصور: مات في سنة 169هـ، وكان مولده في سنة 126، أو 127، أو 121هـ، فيكون عمره عند موته 43، أو 42 سنة أو 48 سنة. (نفس المصدر 10/156).
ومنهم: موسى الهادي ابن المهدي العباسي (147-170هـ) ، مات وله من العمر ثلاث وعشرون سنة، ومدّة خلافته ستة أشهر. (نفس المصدر 10/163).
ومنهم: هارون الرشيد: توفي في سنة 193هـ.
قال ابن كثير:
كان مولده في شوال سنة ست وقيل: سبع، وقيل: ثمان وأربعين ومائة، وقيل: إنّه ولد سنة خمسين ومائة، وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة، بعهد من أبيه المهدي. (نفس المصدر 10/222).
فعلى هذا يكون عمره عند موته: 47 سنة، أو 46، أو 45، أو 43 سنة.
ومنهم: محمد الأمين ابن هارون الرشيد، وُلد في سنة 170هـ، وقُتل في سنة 198هـ، وعمره عند قتله 28 سنة. (نفس المصدر 10/252).
ومنهم: عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد: توفّي في سنة 218هـ، وله من العمر 48 سنة. (نفس المصدر 10/293).
ومنهم: محمد المعتصم ابن هارون الرشيد: ولد في سنة 180هـ، وتوفّي في سنة 227، وله من العمر 47 سنة. (نفس المصدر 10/309).
ومنهم: هارون الواثق ابن المعتصم: توفّي في سنة 232هـ، وكان عمره 36، وقيل: 32 عاماً. (نفس المصدر 10/323).
ومنهم: جعفر المتوكِّل ابن المعتصم: قَتله ابنه المنتصر في سنة 246هـ، وكان مولده سنة 207هـ، فيكون عمره عند قتله 39 سنة. (نفس المصدر 10/364).
وهكذا كثير منهم، كانت أعمارهم قصيرة.
وأمّا في العصر الحديث فمنهم: أدولف هتلر (1889- 1945م)، الذي انتهت حياته بالانتحار بعد أن هزمه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، واحتلّوا برلين، وكان عمره 56 سنة.
ومنهم: صدام حسين (1937-2003م) الذي انتهت حياته بالسجن، والمحاكمة المهينة له، ثمّ بالإعدام شنقاً، وكان عمره 66 سنة.
وغيرهم كثير، ولو أردنا أن نتتبّعهم لطال بنا المقام، وحال كثير من الحكّام الظلمة معروف، وسيرهم مشهورة ومدوّنة في الكتب، وأكثرهم قُصمت أعمارهم.
هذا ما يتعلّق بعقاب الظالمين في الدنيا، وأمّا الأمراض فإنّ الله تعالى أيضاً يعاقب بها الظالمين والعاصين، ويجعلها حجّة عليهم؛ لأنّه سبحانه لم يدفع عنهم الأمراض ليتوبوا، ويرعووا عن ظلمهم، فإذا لم يتوبوا قامت عليهم الحجّة.
كما أنّه سبحانه يثيب المؤمنين الموحّدين بما يصابون به من أمراض وعِلَل وأوجاع وما شاكل ذلك.
فقد روى الشيخ الكليني قدس سره بسنده عن أحدهما عليهما السلام قال: سَهَرُ ليلةٍ من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة. (الكافي 3/114).
وبسنده عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حُمَّىٰ ليلة تعدل عبادة سنة، وحمّىٰ ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمّىٰ ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة.... (نفس المصدر).
وبسنده عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حُمّىٰ ليلةٍ كفارةٌ لما قبلها ولما بعدها. (نفس المصدر 3/115).
5- استدراج الظالمين: فإنّ الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنّه يملي للظالمين في هذه الدنيا، فلا يعاجلهم بالعقوبة، وإنّما يعطيهم ما شاؤوا من الأموال والرجال والسلاح وغير ذلك ممّا يزدادون به عتوًّا وبَطَراً وطغياناً وظلماً؛ لكي يزدادوا إثماً، ثمّ يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما قال سبحانه: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [آل عمران: ١٧٨].
وقال تعالى: (سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) [القلم: ٤٤، ٤٥].
وقال عزَّ من قائل: (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا * وَبَنِينَ شُهُودًا * وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا) [المدثر: ١١-١٧].
والله سبحانه وتعالى إنّما يمهلهم لأنّه لا يخشى فوتهم منه وهربهم من عدله، ولا يَعْجَل إلا من يخاف الفوت، فعدم معاجلة هؤلاء الظالمين الطغاة بالعقوبة في الدنيا ليس خيراً لأنفسهم، وإنّما هو شرٌّ لهم.
وأمّا المريض فإن كان صالحاً فإنّ مرضه كفّارة لذنوبه كما مرّ، وكلّما طال مرضه أعطاه الله من الثواب ما يعطي الصابرين على بلائهم، وأمّا إذا كان المريض عاصياً فإنّ مرضه إمّا عقوبة له، أو تذكيراً له لكي يتوب ويندم على ما اقترفت يداه؛ لكي يَفِدَ على الله تعالى - إن تاب - وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمُّه.
6- محبة الله لأصوات الداعين: فإنّ الله تعالى يحبُّ من عبده أن يجأر إليه بالدّعاء وطلب الحاجات، وأن يتوسّل إليه في قضائها، ومن تلك الحاجات طلب رفع الظلم عنه، وطلب شفائه من كلّ داء وسقم، وغير ذلك.
قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر: ٦٠].
وقال سبحانه فيما حكاه عن نبيّه نوح عليه السلام: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ * فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ) [القمر: ٩،١٠].
فلو أنّ الإنسان لا يمرض ولا يُظلم ولا تصيبه أي بليّه لانقطعت صِلَتُه بربّه، ولعلّ ذلك يؤدّي به إلى التمادي في فعل الآثام والذنوب، والانحدار سلوكيًّا وأخلاقيًّا.
والحاصل أنّ عدم معاجلة الظالمين بالعذاب والهلاك، وعدم شفاء المرضى لا يدلّان على عدم وجود الله سبحانه كما توهّم السائل، بل كلّ واحد من هذين الأمرين وغيرهما من البلايا فيه مصالح كثيرة عرفنا بعضاً منها، ولعلّ ما خفي علينا أكثر ممّا عرفناه منها.




